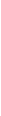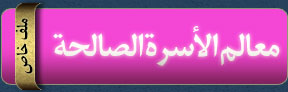۰۰/۰۲/۱۹

ما هو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة23)
الطريق إلى حب الله تعالى هي الإنصات إلى كلامه وطاعته!/ إطاعة الله تعالى تلقي محبّتَه في قلب الإنسان بالتدريج/ يتصور البعض أن المؤمن يتخلّى عن منافعه من أجل "أوامر الله"!/ أمرُ الله يجلب للإنسان أقصى منفعة
-
المكان: طهران، مسجد الإمام الصادق(ع)
-
الزمان: 28/أيار/2019 ـ 22/رمضان/1440
-
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟
-
A4|A5 :pdf
حين ننفّذ أوامر الله تعالى تحقيقًا لمنفعة أنفسِنا سنبلغ مقامًا يصبح فيه "أمرُ الله وعصيانه أنفسهما"، شيئًا فشيئًا، مهمَّين بالنسبة إلينا حتى تصير "حرمةُ أمرِ الله" عندنا أهم من تحصيل النفع أو دَرْء الضرر الناشئ عن المعصية؛ يعني أن نخاطب الله: "إلهي، بِغَضّ النظر عما ينفعني أو يضرني، فإني قد أهنتُك بارتكابي الخطيئة".
إذا صدر "الأمرُ" ولم تمتثله فهذا "ذنب"!
- بعد المقدمات التي قدمنا لها في المحاضرات الفائتة نريد الآن أن ندخل صُلب الموضوع؛ وهو: "ما هي فلسفة الذنب؟ ما الذي يحصل حتى ينشأ مفهوم اسمُه الذنب؟"
- إذا صدر "الأمرُ" ولم تمتثله فهذا "ذنب"! أما إذا لم تُبالِ بموضوعِ "أمرِ الله" فقد يُسمَّى أيُّ خطأ ترتكبُه "خطيئة"، أي إنه لا يعود يُسمّى ذنباً أو معصية؛ ومعناه: "إنّي وقفتُ في وجه الله تعالى!" في حين أنّ معنى الذنب أو المعصية هو وقوفُك أمامَ أمرِ الله.
أيّهما أهم: "أن أقفَ أمامَ أمرِ الله"، أم "أن أفعلَ ما يضرّني"؟
- علينا في الأساس أن نرسّخ هذه الفكرة في أذهاننا، وهي أنّ أصلَ "الوقوف في وجه الله" يعني أننا نفعل ما يضرُّنا! لكنّه من نقطةٍ ما فصاعدًا لا بد أن يكون "وقوفي في وجه الله!" أهمّ عندي من "أنّني تصرّفتُ بما فيه مضرَّتي"! وبعبارة أخرى: أن تصبح "عدم مراعاتي حُرمةَ أمْرِ الله" بالنسبة إليَّ أهم من "أني أضرَرتُ بنفسي".
- ثمة منهاج (اسمه الدين) هو لي مفيد، وعليَّ أن أنفّذَه. كما أنّ الله تعالى، ومن فَرطِ حبّه لي، قد وجّهَ إليَّ أوامرَ. ومن أجل أن تزدهر خصلة "العبودية" في نفسي فمن الأفضل لي أن أُطيع هذه الأوامر لكي أكون عبدَ هذا المولى (الله)، لا عبدَ أحد آخر، ولكي أنتفع من عبوديته.
إذا عظُمتْ "حُرمة أمر الله" في نظرك أصبح أمرُ الله عندك أهمَّ من منفعتك الشخصية
- بعد اهتمامي، لمدة من الزمن، بموضوع "أمر الله" تصلُ بيَ الحال، تدريجياً، إلى حيث لا أرى منفعتي في تنفيذ هذا الأمر، بل يصير المهم عندي هو مجرّد "كونه أمرًا". بالطبع من المعلوم أن كل ما يأمر به الله هو لمصلحتي، وأنّي إنْ لم أُطِع ففي ذلك مضرّتي. لكن بما أنّ الله عز وجل قد تدخّل هو في القضية - بدافع ما يُكِنّه لعبده من حب، وعلى خلفية أنه لا سبيل أمامي للازدهار غير امتثالي أوامرَ ربي – فقد وضعَ تعالى هذا المنهاج بطريقة "أمرية" وصارَ يأمرني، فباتَ "أمرُ الله" الآن أكثرَ أهمية عندي. أي إن الأمر يصلُ بالإنسان، لدى تنفيذه لأمر الله، إلى حيث لا يعود ينظر إلى منفعته الشخصية، بل إلى أمرِ الله وحسب.
- لا شك أنّ القائل: "إلهي، اعفُ عني فقد عصيتُك" ملتفتٌ أيضًا في قرارة نفسه إلى أنه، في الحقيقة، قد أضرَّ بنفسه حين اقترف المعصية. إلا أنّ "حرمةَ أمر الله" عنده قد عظُمتْ عَظَمةً حتى استحيَى من ربه، وانقبضَ صدره لما سبّبتْه المعصيةُ له من ابتعادٍ عنه عز وجل. على أن شخصًا كهذا ملتفت أيضًا إلى منفعته، غير أن محور اهتمامه هو أنه: "إلهي، لقد عصيتُك".
لماذا تطرح بعض الأدعية موضوع النفع والضرر؟
- يتعيّن على الإنسان من أجل التديّن والإقلاع عن الذنب أن يكون نفعيًّا أولًا. على أنه لن يفارق هذه النفعية حتى نهاية المطاف؛ فمهما أقلع المرء عن المعاصي إلى نهاية عمره فهو في مصلحته، حتى إذا ذاق الشهادة.
- حينما نواصل تنفيذ أوامر الله تعالى طلبًا لمنافعنا سنبلغ، رويدًا رويدًا، مرحلةً يصبح فيها موضوع "الأمر" وموضوع "عدم معصية الله" أنفسهما مهمَّين لنا إلى درجة أننا لا نعود نتحدث عن منافعنا. وإنْ نحن ذكَرْنا منافعَنا في مناجاتنا لربنا فذلك من أجل أن نثيره بقولنا مثلًا: "إلهي، إنك لتُحبّ أن لا أخسر. انظر، ها أنا قد خسرت! فخُذ بيدي إذن وإلا هلكتُ!" إذذاك سيقول الله تعالى: "لا يا عبدي، لن أدعك تهلك...".
- قد يقال في المناجاة: «ظَلَمْتُ نَفْسِي» (دعاء كميل). لكن الأهم بالنسبة إلى أمير المؤمنين(ع) – الذي نطق بهذه الجملة في دعائه – هو أن يقول: "إلهي، لقد تجرّأتُ عليك!" فما بالُه(ع) إذن يتحدث عن نفسه؟ إنه يتحدث عن نفسه لأنه يعلم أنه عزيز جدًّا عند الله.. لأنه يعرف أنّ العبد إنْ قال لربه: "ظلمتُ نفسي" فسيرحمه ربُّه؛ لأن الله يحب عبده محبة الأم لطفلها.
يتصور البعض أن المؤمنين يتخلّون عن منافعهم من أجل "أوامر الله"!/ الاهتمام بأمر الله يجلب للإنسان أقصى منفعة
- إنّ خطابَ عبدِ الله لربّه في دعائه: «ظلمتُ نفسي» هو، في واقع الأمر – وبتعبيرنا القاصر – محاولة منه لاستدرار عطفه عز وجل. لأنّ العبد سيصل، شيئًا فشيئًا، إلى حيث لا شيءَ مهمَّ لديه غير أمرِ مولاه، وعندها ستكون ألَحّ قضية عنده هي قضية معصية الله تبارك وتعالى وأنه: "إلهي، بعيدًا عن نفعي أو ضرري، فإنّي قد تجرّأتُ عليك". على أن هذا بالذات يجلب للإنسان أقصى منفعة؛ فأنْ يرى الإنسانُ لربه حُرمةً هو في حد ذاته فرار من الضرر والخسران. من هنا فإن المؤمنين والمتقين يحرصون دومًا على أمر الله ويحترسون لئلا "يُذنبوا" إلى درجة أنّ الغرباء يسيئون الفَهم إذا رأوهم ظانّين أنهم وضعوا منافعهم جانبًا وما عادوا يلهجون بغير "أمر الله"!
- وإن من الواجب علينا أن نبدّد سوء الفهم هذا، سواء بالنسبة إلى أنفسنا أو إلى الآخرين. فبالنسبة إلينا يتحتم علينا، أوّلًا، أن نكون طالبي منفعة، ثم نتقصَّى أين تكمن أعظم منفعة لنا؟ فإنْ وجَّه إلينا اللهُ تعالى أوامر علِمنا أنه يلطُفُ بنا إذ يوجّه إلينا الأوامر وأنّنا نجني منافعَ لنا بامتثالنا أوامره. كما يجب أن ندرك أن الله عز وجل إنما يُظهِر محبّتَه لنا إذ يوجّه إلينا الأوامر، وأنّ علينا أن نلمس محبته تجاهنا وراء أوامره هذه، فنستشعر الشكر له، ونبتهج لذلك أيما ابتهاج.
يجب أن ندرك أن السبيل إلى جَنيِنا المنافع هي امتثال "أوامر الله"
- لا بد أولًا أن نصل إلى درجة من الفهم نُدرك فيها أنه مهما وَجَّه الدين إلينا من أوامر فهو لمصلحتنا نحن وهو يبغي أن نجني نحن أقصى اللذات في هذه الدنيا تحديدًا، وأننا إن لم نتديَّن نكون قد أفسَدنا دنيانا وآخرتَنا على حد سواء. فإن رسختْ هذه الفكرة في رؤوسنا توجب علينا أن نعلم أن السبيل إلى جنيِنا المنافع تكمن في طاعة الأوامر، لا في أن نصنع ما تُمليه علينا أنفسُنا! وأن الله سبحانه وتعالى قد تلطّف علينا إذ أبلغَنا هذه الأوامر.
- لو نعيش في أجواء الأوامر الإلهية قليلًا فسنجد، تدريجيًّا، أن أمر الله، بل الله نفسه سيبلُغ عندنا من الأهمية ما يجعلنا، في بعض الأحيان، ننسى منافعَنا ومَضارّنا ونحن ننفّذ أمر الله! بالطبع هذا لا يعني أن أمر الله يناقض منافعنا، بل يعني أنه يحظى عندنا بأهمية أكبر.
طاعة الله تُلقي في قلب الإنسان، شيئًا فشيئًا، حُرمة الله وحُبّه/ السبيل إلى حُب الله تعالى لمَن أرادَه هي "امثتال أمره"
- الواقع أنه في الأجواء العسكرية والمعسكرات لا أهمية للقائد نفسه حين يصدر الأوامر، بل هو يصدرها لتمشية أمور القتال، وحفظ أرواح الجند، ...الخ، غير أن طاعة الجند له - بحد ذاتها - تعمل، تدريجيًا، على إلقاء هيبته في قلوبهم وخَلْق حُرمةٍ له في نفوسهم إلى درجة أن الجند المُؤتمِرين به يأخذون بحبه، بل ويجدون في أنفسهم الاستعداد للتخلي عن منافعهم وبذل النفس في سبيله! أي تنشأ للقائد في أنفسهم، بعد مدة من الزمن، حُرمةٌ فلا تلبث أن ترى الجندي وهو يضحي بنفسه من أجل قائده!
- حين تكون «القوة» معقولة يتقبّلها الإنسان، ومن ثم يبدأ - رويدًا رويدًا - بحب مصدرها. فماذا لو كان مصدر هذه القوة رب العالمين؟ لا شك أن حبًّا غامرًا لله عز وجل سينشأ في النفس. من هنا فإن أراد المرء أن يحب الله تعالى فإن السبيل إلى ذلك "امتثال الأوامر"، السبيل إلى ذلك هي الاعتذار من الله عز وجل بإلحاح إذا ارتكب خطيئة لأنه يكون قد عصاه. ولقد أُلقي الضوء على هذه النقطة في رواياتنا بشكل كامل، فقالوا(ع): «لَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِ الْخَطِيئَةِ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى مَنْ عَصَيْتَ» (الأمالي للطوسي/ ص528)؛ أي يصبح أمر الله وحرمته هاهنا أشد أهمية من النفع الذي لم تنَله أو الضرر الذي حاق بك.
يصبح موضوع المعصية مُهمًّا للمتدينين بمرور الوقت/ لا يستطيع الناس أن يكونوا حسّاسين للمعصية منذ اليوم الأول
- أن يكون موضوع معصية الله تعالى "وعدم ارتكاب الذنب" عند المتدينين موضوعًا محوريًا وعلى قدر كبير من الأهمية فهذا يحصل بمرور الوقت ولا يستطيع الناس أن يشعروا فجأةً، منذ اليوم الأول، بحساسية تجاه هذه المسألة. بعبارة أخرى: ليس لنا القول: "ألستَ مؤمنًا بالله؟! إذن لماذا أذنَبت؟" فهذا يجعل الناس ينفرون!
- لا بد، في المرحلة الأولى، أن تخاطب الشخص: "إن الذنب خسارةٌ لك، وإن في عدم ارتكابه منفعة لك...". ثم تعمد، في المرحلة الثانية، ولمنع سوء التفاهم، إلى أن تُرسّخ في ذهنه فكرة أن الله عز وجل إذ يأمرنا فذلك لفرط حبه لعباده؛ فلأنه يحب رسوله(ص) أكثر فلقد أوجب عليه صلاة الليل؛ فإنْ تركَ رسولُ الله(ص) صلاة الليل فقد عصى! فالله تبارك وتعالى إذن يوجّه الأوامر لكل من يحبه!
- فإن رسَخَ في النفس موضوعُ منفعتنا وحُب الله لعبده، فيما يتصل بالمعصية، كان على المرء أن يتمرّن على الطاعة مدة من الزمن، فإن تمرّن قليلًا تسلّلتْ هيبةُ الله تعالى إلى قلبه شيئًا فشيئًا! فإن استقرّت هيبة الله في قلبه يكون قد بلغ مرحلة: «وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى»، أي عن الرغبات التافهة، فسيَسعَد ويكون مصيره الجنة: «فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى» (النازعات/41).
علينا اجتياز ثلاث مراحل كي تتولّد للذنب ومعصية الله عندنا حُرمة:
- إذن في وسعنا هنا تصوّر مراحل ثلاث: الأولى هي أن ندرك أن تنفيذ أوامر الله تعالى وعدم معصيته يصب في مصلحتنا. والمرحلة الثانية هي أن نفهم أن الله إنما جعل هذا المنهاج أمريًّا، ووجّه الأوامر، وجعل لذلك الجنّة والنار لحُبّه لنا. وأما المرحلة الثالثة فهي أنّ هيبة الله عز وجل، على اعتباره "قائدًا"، ستستقر بالتدريج في قلب مَن يمتثل أوامرَه، بل إنه سيحب الله رويدًا رويدًا.
- وثمة، بالطبع، في هذا الخِضَمّ مسائل أخرى، أُشيرَ إليها في المحاضرات الماضية؛ فمثلًا إننا إن لم نمتثل أمرَ الله ولم نصبح عبيده فسنصير - لا محالة - عبيدَ غيرِه. فنحن معاشر البشر طُعومٌ لذيذة للأغيار والطواغيت الذين يودّون لو يتسلّطوا علينا، إلى درجة أنّ علينا اللواذ بالله مخافة ذلك!
- إن من أشد أصناف العذاب الإلهي، وهو ما تكرّرَ مضمونه في القرآن الكريم، هو قول الله جل جلاله لبعضهم: "لن أُحامي عنك وأساندك بعد اليوم، إنك لا سند لك..." وهذا كلام عظيم جدًّا. أي إنني إن لم أساندك وأحميك فستطحنك هذه العجلات المسننة للدنيا، وسيستعبدك إبليس، وتتحطّم في سبيله، وينتهي بك الأمر إلى نار جهنم!
لقد أرادت بريطانيا وأمريكا استعبادنا كما فعَلتا بالهنود!
- إننا إن أصبحنا عبيدًا لغير الله فسيستغلنا غيرُ الله أو الطاغوت هذا لمصلحته، ويستعبدنا، وفي النهاية يسحقنا. على سبيل المثال كان البريطانيون يجلبون الجنود الهنود إلى سواحل إيران لقتالنا فكنا، إذا أردنا قتال البريطانيين، نقتل الجنود الهنود! فكان هؤلاء الأخيرون يُسحَقون في هذا الخِضَمّ. من أجل ماذا؟ من أجل بريطانيا الخبيثة!
- لقد أراد البريطانيون والأمريكان استعبادَنا، كما استُعبِد الهنود من قبل! من أجل ذلك فإنه عندما غَزا البريطانيون بلدَنا هبّ لمواجهتهم أمثالُ "الشهيد دلواري"، ذلك أن أمثال الشهيد دلواري كانوا يأبون أن نُصبح عبيدًا للبريطانيين الخبثاء كالهنود. فهل تراهم يُحسنون معاملتنا إن أمسينا لهم عبيدًا وخَدَمًا؟ كلا، إنهم يرسلون عبيدهم للموت في سبيلهم!
إنّ مَن لا يُنفق ويضحّي في سبيل وليّ الله فسيفعل ذلك في سبيل عدوه!
- عن الإمام الصادق(ع) قوله: «مَنْ لَمْ يُنْفِقْ فِي طَاعَةِ اللهِ ابْتُلِيَ بِأَنْ يُنْفِقَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ لَمْ يَمْشِ فِي حَاجَةِ وَلِيِّ اللهِ ابْتُلِيَ بِأَنْ يَمْشِيَ فِي حَاجَةِ عَدُوِّ اللهِ عَزَّ وَجَلّ» (من لا يحضره الفقيه/ ج4/ ص412). فكل من لا يعمل لصاحب الزمان(عج) عملًا جهاديًّا فسيُنفق بعضَ عمره، لا محالةَ، يخدم عدو صاحب الزمان(ع) خدمة جهادية ويتحطّم في هذا السبيل! الكل سيؤول إلى هذا المصير؛ أي إنهم سيبدؤون، من مرحلة ما فصاعدًا، بالتضحية بوجودهم في سبيل غير الله أو عدو الله؛ مثل أهل الكوفة الذين بذلوا وجودهم ليزيد، فكان أن وقع مصيرهم في يد مجرم سفاح مثل الحجاج الثقفيّ!
إنْ قَنَعنا بالقليل من المنفعة استُعبِدنا!
- المرحلة الأولى هي أن أفهم أن منهاج الدين هذا وأوامره فيها نفعي أنا. على أن علينا أن نطلب أقصى منافعنا، لأننا إن قنَعْنا بالقليل من المنفعة استُعبدنا! فإن قيل لك: "كم تريد أن تستمتع؟" قل: "أريد أن أستمتع كل الاستمتاع! أريد أن ألتَذّ بأعظم لذّات العالم!"
- فإن قلتَ: "أكتفي بقليل من المتعة" قيل لك: "تعال، إذن، وكن غلامي، فأنا أمنحك هذا القليل!" إنك إن صرتَ عبده فإنه لن يدعك - وهو عدوّك - تجني أعظم لذّات العالَم، ألا وإن أعظم لذّات العالم هي المعنوية منها؛ إنه لن يذرك تستمتع بلذة كونك حرًّا والعيش بحرية، ولا بلذة حرية الاختيار.. إنه سيعطيك بضع لذات مبتذَلَة؛ كلذة الانصياع وراء النزوات الجزئية، ولذة الجلوس على ساحل البحر، ...الخ، ولا يدعك تستمتع بأكبر اللذات، لا يذرك تجني أعظم المفاخر.
عندما يكون لأمر الله عندي حُرمةٌ وأعصيه فسأدرك أنني فعلتُ ما يضرّني، وسأستحي من الله أيضًا
- إذن على المرء، في المرحلة الأولى، أن يفقه جميع منافعه ويعرفها، ويهيِّئها لنفسه، وأن يجتنب كل ما يضره، وأن يدرك أن الدين منهاجٌ الغرضُ منه هو ضمان منافع البشر.
- ثم أن يفهم، في المرحلة الثانية، أن: لماذا زوّدَه الله تعالى بهذا المنهاج "على شكل أوامر". الجواب: لبضعة أسباب؛ الأول: هو أنه تعالى يحبّه. إذن "فرغبة الإنسان في المنفعة"، مضافًا إلى "رغبته في أن يكون محبوبًا والشعور بالطمأنينة في أحضان رَبّ يحبه" تحرّضه على امتثال أوامر هذا الرب.
- أما المرحلة الثالثة فهي أنني حينما أطيع الله فستستقر هيبتُه تعالى، تدريجيًّا، في قلبي بصفته "قائدًا"، ويتسلل الخوف من مقامه إلى نفسي شيئًا فشيئًا فأحسب له ألف حساب. وبِغَضّ النظر عن أنني سأدرك - إذا عصيتُه - أنني قد تصرّفتُ بما فيه خسراني، فإنني سأخجل ويغمرني الحياء منه؛ بمعنى أنني - بعيدًا عن مسألة الربح والخسارة - سأحس أنّ هذه العلاقة العاطفية بيننا قد انثلمتْ، فأستحي منه، وأشتاق إليه. فارتكابي الخطيئة سيجعلني أشعر بأني قد انتهكتُ حرمة ربي. وهنا تحديدًا يصل المرء، للتوّ، إلى ظاهرةٍ اسمُها "الذنب"، وسيؤَنّبُه ضميرُه لاقترافه، ويتألّم، ويندم، وتطرأ عليه تحوّلات روحية تتكشّف عن الاستغفار.
إذا صار المرءُ حسّاسًا تجاه الذنب يكون قد استوعب لتوّه أصلَ الدين
- إذا بلغ المرء مرحلة أنه صار حساسًا تجاه الذنب فإنه يكون قد استوعب لتوّه أصل الدين. ولقد بيّنَت الأحاديث الشريفة ملاحظات جمة حول الذنب؛ مثلًا: لا يحق لامرئ زرع اليأس في قلب المذنب، ولا يحق لأحد أن يَيْأس من أيما عاصٍ، إذ من الممكن أن يأخذ الله بيده فيتوب عليه! ولا يجوز لعاصٍ أن يَقنَط، بل أن يسأل الله العون والمساعدة.
- مَن تكون للمعصية حرمةٌ عنده تراه ينزعج حقًّا إن عصى ربه لأنه قد انتهك حرمة أمر الله عز وجل. شكَى أحدهم للإمام الصادق(ع): إنّي أُدمِنُ معصيةً لا أستطيع الإقلاع عنها، وكلما أقلعتُ عنها واستغفرتُ، عُدتُ إليها.. إنني أتحطّم! «...قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَمُقِيمٌ عَلَى ذَنْبٍ مُنْذُ دَهْرٍ أُرِيد أَنْ أَتَحَوَّلَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْه». فكان رد الإمام(ع) أن هذه علامة حب الله لك: «قَالَ لَهُ: إِنْ تَكُنْ صَادِقًا فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّكَ، وَمَا يَمْنَعُكَ مِنَ الِانْتِقَالِ عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَخَافَه» (الأمالي للمفيد/ ص12-13)؛ أي إن الله يُبقيك مقيمًا على بابه بواسطة هذا الذنب بالتحديد. فمن أجل أن تخاف الله و لا يغادر هذا الخوف قلبَك فإن الله عز وجل لا يوفّقك إلى ترك هذه المعصية. فلقد تعاظمتْ عنده حرمة الله وحرمة المعصية إلى درجة أنه بات يتألم بسبب ارتكابه هذه المعصية، ومن خلال هذا الشعور بالألم يقوّي الله تعالى هذه الآصرة بين هذا العبد ومولاه.
- إنّ المرءَ، بحسب بعض الروايات، قد يدخل الجنة بسبب معصية! لكن كيف؟ يقال: إن العبد ليذنب، وإذا بباصرةِ قلبه تنفتح، فيستحي أيما حياء، ويجتهد في الإصلاح أيما اجتهاد، ويتألم أيما تألُّم حتى يدخل الجنة جراء تألّمه هذا! كل هذا حصل بسبب حرمة المعصية؛ عن رسول الله(ص) قوله: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ فَيَدْخُلُ إِلَى اللهِ بِذَنْبِهِ ذَلِكَ الْجَنَّةَ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَكُونُ ذَلِكَ الذَّنْبُ نَصْبَ عَيْنِهِ تَائِبًا مِنْهُ فَارًّا إِلَى اللهِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّة» (أمالي الطوسي/ ص530).
لا بد أن يكون للذنب عند الإنسان من الحُرمة ما يبلغ به حد اليأس...
- هذه كلها مسائل تحصل بسبب قضية "حُرمة الذنب". لا بد للذنب أن يبلغ عند الإنسان من الحرمة ما يدفعه إلى مشارف اليأس، فيأخذ الله حينئذ بتأميله بقوله: أنا أحب التوّابين: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ» (البقرة/222). لا بد للمعصية أن تؤذي صاحبَها حتى ليتحطم الأخير من فرط الأذى، وعندها يقول له ربه: "سأمحو لك معصيتك"، فيقول العبد: "إلهي، أنا شاكر لك أنك تمحو معصيتي، لكن كان ينبغي لصحيفتي أن تمتلئ بالصالحات! وكل ما فعلتَه أنك محوت المعاصي منها، فما عسايَ أصنع الآن؟ كيف أملأ كل هذا الفراغ؟!" فيجيب الله تعالى: "أنا مُبدِّل السيئات بالحسنات.. أنا الذي سيفعل ذلك!"
- حين تصبح للمعصية عند فاعلها حُرمة يودّ لو يطيل الوقوف عليها دومًا، ويقف على أعتاب ربه يتحدث إليه عن ذنوبه. يحب أن يُكثِر من قول: "أستغفر الله ربي وأتوب إليه". وهذا نمط آخر من المعنويات.. إنه عالَم بحد ذاته! والكثير من المتديّنين لم يدخلوا إلى هذا العالم بعد!
- الذي يصير الذنبُ عنده ذا أهمية سيحترس دائمًا من أن يُذنب، وسيُكثر من الاستغفار. وكما أسلفنا في بدايات البحث عليك أولًا أن تحاذر من التفريط بمنافعك ومن أن تخسر. فإن وجدتَ الطريق السَوِيَّة إلى نيل المنافع فستدرك أن الله تعالى وحده هو القادر على حفظ منافعك، وعندها ستسلِّم نفسك – تدريجيًّا – إلى ربك قائلًا له: "إلهي، احفظ أنت منافعي، وسأنفّذ أنا أوامرك!" وإذذاك ستحصل في حياتك أحداث جميلة؛ كقوله تعالى مثلًا: «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ» (الطلاق/2-3)؛ "أنت اتَّقِني.. أنتَ فقط حاذر في كل حادثة من ارتكاب الذنب، وانظر ماذا سأصنع لك! لا تشغل بالك بأي شيء آخر!"
- «مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ» ليس هو مما يحدث صدفة، بل هو طريقة ونهج؛ إنها سيرة الله تعالى في التعامل مع المؤمنين والمتقين. الأخيرون سيعيشون حياةً جديدة تمامًا.. سيعقدون مع الله صفقة، وسيعملون معه ليل نهار.. إنهم لن يعودوا قادرين على العمل من دونه!
لماذا يحب المؤمنون الإكثار من الاستغفار؟
- ولكي تتولّدَ للذنب عند الإنسان حُرمة فإن عليه اجتياز بضع مراحل: الأولى أن يكون "عدم ارتكاب الذنب" عنده مهمًّا جدًّا. والثانية أن يبلغ مرحلة يطيل فيها الكلام مع ربه حول معاصيه، ويستغفره. وهذا ما يفسّر لماذا يُكثِر أولياء الله من الاستغفار. على أن دائرة الاستغفار واسعة جدًّا؛ فإنّ له أيضًا مراتبَ عالية جدًّا، حتى لَيبدو أنه لا يُستغفَر للمعصية فحسب، بل هناك أسباب أخرى له.
- يبلغ المرء في هذه المرحلة إلى حيث يستشعر الخطيئة على نحو موصول، ويرى سلبياته. على حين أن الإنسان لا يحب كثيرًا النظرَ إلى مكامن ضعفه، أو مشاهدة مَواطِن خسرانه، ولا يود الإكثار من التحسُّر، إذن لماذا يحب المؤمنون الإكثار من الاستغفار؟ لأنهم ما إن يستغفروا حتى يشهَدوا من ربهم لطفًا ومحبّة؛ فهو القائل: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ».
- مَن يعتذر إلى الله تعالى يلمس لُطف الله به ويدرك أنه عز وجل يلاطفه بنظرته الحنون، وإن هذا لإحساس ممتع حقًّا.. أَوَيُعقَل أن تعتذر إلى ربك فلا ينظر إليك نظرة لطف، ولا تستمتع أنت؟! فماذا لو ترك الإنسان المعصية؟ في الحديث إن الله يذيق مَن ترك الخطيئة لذّةً معنوية من لدنه ما لم يكن ليذوق مثلها لو أنه ارتكب تلك الخطيئة! «...فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللهِ أَعْطَاهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِه» (جامع الأخبار/ ص145)، «مَنْ أَعْرَضَ عَنْ مُحَرَّمٍ أَبْدَلَهُ اللهُ بِعِبَادَةٍ تَسُرُّه» (أمالي الطوسي/ ص182). وبوسعك أن تجرّب هذا منذ اليوم؛ فإن فُسِحتْ لك فرصة الاستغابة مثلًا فلا تستغب، وانظر أي دفء سيغمر وجودَك! لماذا؟ لأن الله تعالى فَرح بتصرّفك.
- لم يكوّن البعضُ إلى الآن علاقةً مع ربه، علاقةً محورها "الذنب". فليس مثل الذنب شيء يمكنه أن يشكّل موضوعَ غرامٍ بين العبد ومولاه! أنا أرتكب الخطيئة، والله يعفو.. أنا أتمادى في ارتكاب الخطيئة، والله أيضًا يُبالغ في العفو! فأقول: "إلهي، صحيحٌ أنك غفرتَ لي خطيئاتي، لكن ماذا عسايَ أصنع بعمري هذا الذي هدرتُه بالعُطْل والبطالة؟" فيقول الله: "سأتدارك الأمرَ لك!"